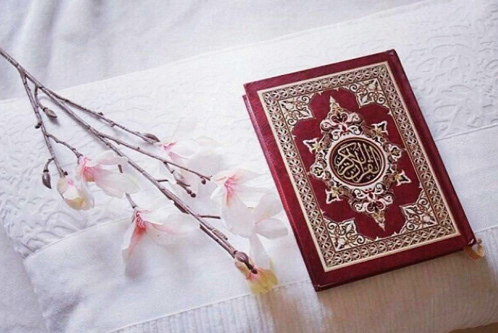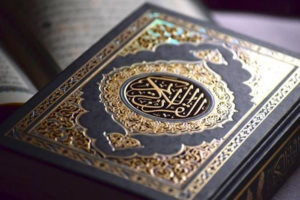بسم الله الرحمن الرحيم
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
كان الوثنيون العرب لا يؤمنون بوقوع القيامة، ويعتبرونها أمرًا مستحيلًا. وذلك لزعمهم أنه يستحيل إحياء الإنسان بعد ما تحول ترابًا.
كما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها (وتنتقده، و لا سيما ما يتعلق بالقيامة)، فنزلت عم يتساءلون (ردا على حديثهم).
بدأ الله عزّ وجلّ هذه السورة قائلا: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
كلمة “النبأ” المذكورة في هذه الآية يراد بها الخبر، ذكر المفسرون أنه يراد منها خبر هائل، والمراد هنا القيامة.
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
كلمة كَلَّا للردع (النفي مع التأكيد)، ومعناها: لا يدركون هذا الأمر بالتساؤل والنقاش والجدال والمراء، بل يعرفون حقيقته عند مواجهته، وهي حقيقة لا مجال فيها للتساؤل والخلاف والإنكار.
وتكرار قوله تعالى: كلا سَيَعْلَمُونَ… ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ للتأكيد على شدّة الأمر وعِظَم هوله، أي عندما يموتون، يُكشَف الغطاء فيشاهدون أهوال الآخرة وحقائقها بأعينهم.
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾
سباتا: راحة
سراجا وهّاجا: سراجا منيرا وهو الشمس
ماء ثجاجا: دافقا منهمرا بشدة وقوة
جنت ألفافا: حدائق وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان
في هذه الآيات إشارة إلى قدرة الله عزّ وجلّ المحيطة التي خلق بها المخلوقات العجيبة في الكون. ومن خلال بيان كيفية الخلق للكون والمخلوقات المختلفة، يُظهر الله تعالى لعباده عظيم قدرته، ويُثبت لهم أنه لا يستحيل عليه أن يُفني هذا العالم بأسره ثم يُعيد خلقه مرة أخرى.
ومن المخلوقات التي ورد ذكرها في هذه الآيات خلق الأرض، والجبال، والإنسان، والذكر والأنثى، وتهيئة الظروف المناسبة لحياة الإنسان وصحته ونشاطه. ومن النِّعم التي ذُكرت في هذا الصدد نعمة النوم.
يقول الله تعالى مشيرا إليها:
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾
ذكر الله عزّ وجل ّكلمة “سباتا”، وهو مشتق من السبت بمعنى القطع، وذلك لأن النوم يقطع هموم الإنسان، فينال بذلك راحة لا ينالها بغير النوم. ولذلك ذكر المفسّرون أن المراد من السبات الراحة.
فالنوم وسيلة عظيمة للراحة للخلق كلهم، الغني منهم والفقير، العالم منهم والجاهل، ملكهم وعاملهم.
وكثيرا ما يستمتع الفقراء – مع عدم توفّر وسادة أو فراش أو أي وسيلة من وسائل الراحة – بنومٍ مريح حيثما حلّوا، بينما يعاني الأثرياء أحيانًا – مع امتلاكهم جميع أسباب الراحة – من الأرق بسبب هموم الدنيا، فلا تغمض أجفانهم إلا بتعاطي أقراص التنويم.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾
في هذه الآية، ذكر الله تعالى نعمة الليل، فعندما يزول ضوء النهار ويُقبل الليل، يجد الإنسان في نفسه ميلاً طبيعيًّا إلى النوم. وقد جعل الله تعالى في الليل سكينةً تعمّ الأرجاء، حيث تغيب الضوضاء والشغب. ومن ثَمّ، يُبيّن الله تعالى في هذه الآية أنّه لم يمنح الإنسان النوم وحده ليكون راحةً له، بل هيّأ كذلك الأحوال الدنيويّة في الليل لتكون صالحة ومناسبة للنوم، حتى لا يُكدَّر على الإنسان نومُه بوجه من الوجوه.
و أضف إلى ذلك أن حالة النوم التي أنعم الله عزّ وجلّ بها على عباده ليست مقصورة على الإنسان، بل تشمل الحيوان كذلك ، في الوقت نفسه من الليل، حتى ينام الجميع في سكينة، ويسود الهدوء العام أرجاء الأرض. ولو اختلفت أزمنة نوم المخلوقات ، لما تحقّق هذا السكون العام ولا هذه الطمأنينة الشاملة.
وفي آية أخرى، يوضّح الله تعالى أنّ هذه النعمة العظيمة – نعمة الليل وما فيه من راحةٍ و سكون – إنما هي بفضل الله تعالى وقدرته وحده. قال الله تعالى:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبصِرُونَ ﴿٧٢﴾
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾
كما يحتاج الإنسان إلى النوم، فهو يحتاج إلى ضروريات أساسية أخرى كالأكل والشرب و اللباس والمسكن. و لذلك لا بد له من كسب مال حلال ؛ ليتمكن من تلبية هذه الضروريات . فلو كان في الدنيا ليل بلا نهار، وظلّ الإنسان نائمًا طوال الوقت، فكيف كان يتمكّن من تحصيل الرزق و تلبية حاجاته اللازمة ؟ لذلك جعل الله تعالى الليل للراحة والنوم، وجعل النهار للسعي والعمل وطلب المعاش .
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾
كلمة “المعصرات” جمع المعصرة، وهي السحب التي تمتلئ بالمطر. هذه الآية تدل على أن المطر ينزل من السحب، بينما تدل آيات أخرى على أن المطر ينزل من السماء، ولا تعارض بينهما، فإن السحب تكون حالّة في السماء. ففي هذه الآية، نسب المطر إلى الحالّ أي : السحب ، وفي الآية الأخرى، نسب إلى المحلّ أي: السماء.
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾
المراد ب “يوم الفصل” يوم القيامة. إنّ يوم القيامة له وقت متعين ومقدَّر، كما ذكر الله تعالى في الآية الآتية من أنه يقع عند نفخ الصور.
وتشير آيات أخرى إلى أنّ النفخ في الصور سيحدث مرّتين: فعند النفخة الأولى يفنى العالم كلّه. وعند النفخة الثانية، يُبعث جميع الناس من الأوّلين والآخرين، ويُحشرون إلى ساحة الحساب أفواجًا وجماعات.
فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم (سنن الترمذي، الرقم: ٣١٤٢)
ورد في بعض الروايات أنّ الناس يوم القيامة سيُحشرون على عشرة أصناف. وقال بعض العلماء: إنّ تقسيم الناس في ساحة الحشر سيقع بحسب أعمالهم وأخلاقهم. ولا تعارض بين هذه الروايات، لأن بعضها تذكر أصنافا، و بعضها تذكر أصنافا أخرى.
وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
كلمة “سُيِّرَت” تدلّ على أنّ الجبال، على رغم كونها هائلة راسخة لا تتحرّك، ستفقد تماسكها وثباتها، وتُقلع عن أماكنها، حتى تصير كذرات من الغبار المتطاير في الجو.
أما كلمة “سَراب” فمعناها الأصلي: الزوال والاضمحلال، ويُطلق كذلك على ما يظنه الرائي في الصحراء ماء من بعيد، فإذا اقترب منه لم يجده شيئا. فهذه الجبال العظيمة الشامخة، التي كانت تبدو للناس قبل قيام الساعة قوية راسخة، ستصير عند وقوع القيامة هباءً منثوراً، تتطاير كالذرات، فتضمحل وتزول كما يزول السراب.
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
المرصاد: المكان الذي يرصد فيه الإنسان العدو أو مراقبة العدوّ وترصده للقبض عليه على حين غرة.
وفي هذا السياق، المراد بجهنم الجسرُ المضروبُ فوقها، حيثُ ينتظر ملائكةُ العذاب وملائكةُ الرحمة المارّين عليه.
فمن كُتِبَ عليهم دخولُ النار، تترقبهم ملائكةُ العذاب فتقبض عليهم وتُورِدهم النار.
ومن كُتِب لهم دخولُ الجنة، فملائكة الرحمة تنتظرهم لتأخذهم إلى دار النعيم.
قال الحسن البصري رحمه الله: إن على النار رصدا (من الملائكة)، لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجئ بجواز حبس
لِلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾
أي: مَرجِعًا ومَأوًى للطاغين.
ظاهر الآية السابقة يدل على أنّ جسرَ جهنّم مَرصَدٌ لجميع الناس – برّهم وفاجرهم – إذ لا بُدّ للجميع من المرور عليه.
وفي هذه الآية الكريمة، بيّن الله عزّ وجلّ أنّ جهنّم ليست دارَ إقامةٍ للأبرار، بل هي مأوى الطاغين.
وكلمة الطاغين تُطلَق على من تجاوز الحدّ في معصية الله تعالى، والمراد بها الكافرُ الذي جحدَ حكم الله عز وجلّ وكفر بدينه،
وقد يدخل فيها كذلك طوائفُ من المسلمين الذين خرجوا عن حدود الكتاب والسنة – وإن لم يبلغوا حدَّ الكفر الصريح – كالروافض والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فمن يعتقد منهم ما يُخرج المرء من الإسلام فهو داخلٌ في حكم هذه الآية.
لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
كلمة “أحقاب” جمع حِقبة، وهي المدة الطويلة.
وقد اختلف العلماء في تحديد مقدارها:
فقد روى ابن جرير رحمه الله عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ الحِقبة ثمانون سنة، والسنة اثنا عشر شهرًا، والشهر ثلاثون يومًا، واليوم كألف سنةٍ من سني الدنيا، فالحِقبة تساوي عشرين مليونًا وثمانية وثمانين مائة ألف سنة.
وقال سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم: إنّ الحِقبة سبعون أو ثمانون سنة، وبقية الحساب كما ذُكر.
يزعم بعض الناس أنّ أهل جهنّم – بعد أن يمكثوا فيها أحقابًا طويلة – سيُخرَجون منها في النهاية، بحجّة أنّ الحقب – مهما طال – مدة محدودة تنتهي يوما ما.
لكن ذكر المفتي محمد شفيع رحمه الله في معارف القرآن أنّ هذا القول باطل، لأنّ الآيات الصريحة الأخرى من القرآن الكريم تردّه بكل جلاء ووضوح. فقد قال الله تعالى في حقّ الكفار: خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (سورة النساء: ١٦٩)
كما أنه قد انعقد إجماع الأمة على أنّ جهنّم لا تفنى، وأنّ الكفار لا يخرَجون منها أبدًا.
وقد روى الإمام السدي رحمه الله عن مرة بن عبد الله رحمه الله أنه قال:
لو علم أهل النار أنهم يلبثون فى النار عدد حصى الدنيا لفرحوا ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون فى الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا (التفسير المظهري ١٠/١٧٥)
فالقول بأنّ الكفار يخرَجون من النار بعد مدّة من الزمن قولٌ باطل مناقض للقرآن الكريم ولـإجماع الأمة.
وينبغي أن يُعلم أنّ هذه الآية لا تذكر ما سيحدث بعد انقضاء الأحقاب، إنما ذكرت أنهم يمكثون فيها أحقابًا، وهذا لا يدلّ على أنّ جهنّم ستفنى أو أنّ الكفار سيُخلَصون منها بعد تلك المدة.
ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله:
إن الله لم يجعل لأهل النار مدة بل قال: لابثين فيها أحقابا، فو الله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخر ثم أخرى إلى الأبد فليس للأحقاب مدة إلا الخلود.
فكلّما انتهى حقب بدأ حقب جديد، وإذا انتهى الثاني بدأ الثالث، وهكذا يتعاقب الأحقاب بلا نهاية.
وكذلك فسر سعيد بن جبير رحمه الله كلمة أحقابًا بأنها أزمانٌ لا تنتهي، كلما انقضى زمن تبعه آخر إلى الأبد.
جَزَاءً وِفَاقًا
أي: هذا العذاب جزاءٌ عادل موافق لأعمالهم وكفرهم، لا يُظلمون فيه شيئًا، بل هذا ما يستحقونه
فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
كان الكفار يستمرّون في الكفر بالله تعالى، ويصرّون على أعمال الكفر والشرك. ولو لم يدركهم الموت، لتمادوا في الكفر والطغيان. ولأجل ذلك، يزيدهم الله تعالى عذابًا فوق عذابهم يوم القيامة، جزاءً لكفرهم المستمر بالله تعالى و تماديهم في الطغيان .
إلى هذه الآية ، تحدّث الله تعالى في هذه السورة عن عذاب الكافرين، و بعد ذلك يذكر ما أعدّه للمؤمنين الصالحين من النعم والبركات.
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
في هذه الآيات الكريمة، يخبر الله عزّ وجلّ أن أهل التقوى – وهم عباد الله الصالحون – هم الذين يحظون بالفلاح العظيم، وما أعده الله لهم من نعيم الجنة، من بساتين وكروم، وحور عين، وخمر لذة للشاربين.
وهذه النعم المذكورة إنما هي أمثلة لما أعده الله عزّ وجلّ لعباده الاتقياء من النعيم، والا فإن نعم الجنة لا تحصى ولا خطرت على قلب بشر.
فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين (صحيح البخاري، الرقم: ٣٢٤٤)
وقال الإمام مجاهد رحمه الله والإمام قتادة رحمه الله: فازوا، فنجوا من النار أي: إن المفاز المذكور في الآية هو النجاة من النار ودخول الجنة.
لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا
أي لا يسمع اهل الجنة فيها كلاما باطلا ولا كذبا، لان الجنة دار الطهارة والكمال، لا يوجد فيها شيء من نقائص الدنيا وآفاتها، كالكلام الفارغ أو الكذب أو الأذى.
جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
أي: إن نعم الجنة التي ينعم بها أهلها جزاء على أعمالهم الصالحة وهو في الحقيقة عطاء من الله عزّ وجلّ.
فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أمرين: الأول أن هذه النعم تُعطى العباد الصالحين جزاءً على أعمالهم، والثاني أنها عطية إلهية محضة. والظاهر أن بين الأمرين تعارضًا، لأن الجزاء يُعطى مقابل عمل، أما العطية فَتُمنح من غير مقابل.
والجواب أن القرآن الكريم جمع بين الكلمتين ليشير إلى أن نعم الجنة جزاء على أعمال العباد في الظاهر ، وأما في الحقيقة فهي منح ربانية خالصة من فضل الله ورحمته.
وذلك لأن أعمال الإنسان – مهما كثرت – لا تكافئ أقل النعم التي يتمتع بها في الدنيا، فكيف بنعم الآخرة التي لا تُنال إلا برحمة الله وفضله.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة (صحيح البخاري، الرقم: ٥٦٧٣)
وأما كلمة “حسابًا” في الآية، فقد فسرها العلماء على وجهين: (١) عطية محسوبة مقدّرة (٢) عطية وافرة غزيرة
فعلى الوجه الأول: يكون المعنى أن العباد يُعطون الأجور بقدر إخلاصهم و اتباعهم لأمر الله تعالى في أعمالهم.
وعلى الوجه الثاني: يكون المعنى أن الله تعالى سيفيض على عباده في الجنة من النعم ما لا يُحدّ ولا يحصى أكثر مما يستحقونها، فيرونها خالصة من فضل الله، لا بمقابلة أعمالهم.
رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا – هذا الجزء من الآية يحتمل أن يكون مرتبطا بما قبله حيث ذكر الله عزّ وجل فيها الأجور والنعم التي يعطيها أهل الجنة. فإذا أراد الله تعالى أن يعطي أحدا شيئا من الجزاء، فلا يملك أحد أن يسأل عن حكمه.
ويحتمل (قوله عزّ وجلّ: لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) أيضا أن يكون مستقلا غير مرتبط بما قبله. فيكون معناه أنه لا يقدر أحد أن يتكلم في المحشر إلا بإذن الله عزّ وجلّ. فلا يتكلم ولا يشفع أحد إلا من أذن له الله تعالى بالكلام أو الشفاعة.
وأما كلمة الروح المذكورة في قوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا – فالمراد بها سيدنا جبريل عليه السلام، وقد خص بالذكر قبل ذكر الملائكة إظهارا لعظمة شأنه ورفعة منزلته.
إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
هذا اليوم هو يوم القيامة. ففي ذلك اليوم، يرى كل إنسان أعماله بعينيه في المحشر.
ورؤية الإنسان لأعماله بعينه تقع على أحد وجهين: ١. أن يعطى كتاب أعماله في يده فيراه ٢. أو تظهر أعماله في المحشر متجسدة في صورة مرئية، كما جاء في بعض الأحاديث.
وقد يراد بهذا اليوم يوم وفاة الإنسان، وقوله عزّ وجلّ : يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، إشارة إلى رؤية أعماله في القبر بعد وفاته. وذكر هذا المعنى في التفسير المظهري.
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الله الخلائق الإنس والجن والدواب والوحوش فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى تقص الشاة الجماء من القرناء بنطحتها فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا، فتكون ترابا فيراها الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا (لأتخلص من الحساب ومن عذاب النار)
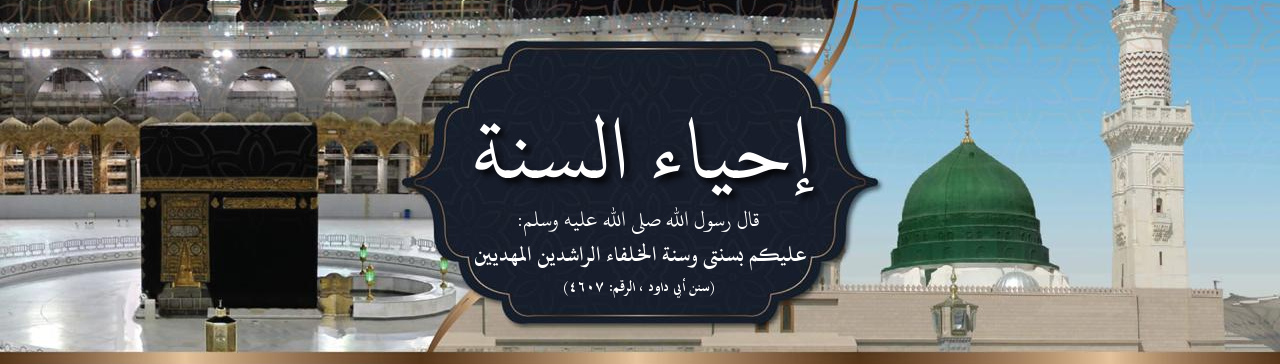 إحياء السنة إحياء سنة رسول الله ﷺ
إحياء السنة إحياء سنة رسول الله ﷺ